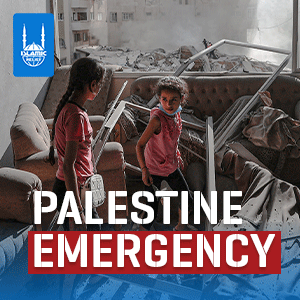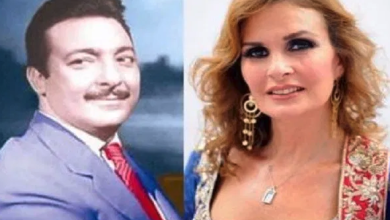أرشيف - غير مصنف
شُنّارْ اَلْفَلَسْطيني
جميل عبود
خلق الله الناس جميعاً من ذكر وأنثى، ولم يُفضّل أحدًا منهم على آخر إلا بالتقوى، وحثهم على تحسين ظروف حياتهم بتعمير أرضهم وإسعاد غيرهم.
لكن سرعان ما استعبد القويّ منهم ضعيفهم وسخّره لخدمته.
وأقنع القويّ الضعيف بضعفه، وأفهمه، بأنّ القوة لله وحده، يهبها لمن يشاء من عباده.
فلا يُمكن للضعيف أن يكون قويًا، لأن الله خلقه ضعيفًا.
وأقنعه أيضًا بأن طاعة الضعيف للقوي واجبة، وإذا عصى الضعيف القوي، فكأنه عصى الله، دون أن يدري أو لا يدري.
وأوحى القويّ للضعيف، بأن الرّزق مكتوب، ومن لم يُرزق في الدُنيا – الزائلة – سيُرزق في الآخرة، وما عليه إلا الانتظار.
فبدأ المسكين يعمل للآخرة، مُنذ نعومة أظفاره، وتناسى الدُنيا، وانفصل عنها، وأصبح في عالم آخر، وتنازل الضعيف عن دوره في الحياة الدُنيا للقويّ طواعيّةً.
هذا على مُستوى الأفراد، وأما على مُستوى الجماعات، فلا يختلف الأمر كثيراً، فقد اتحد الأقوياء في كل جماعة، وسخروا الضعفاء خدماً لهم.
ولم يُقتصر الموضوع على الجماعة نفسها، ولكنه امتد رأسياً، فهناك من يقول: إنهم شعب الله المُختار، وكل ما في الكون سُخّر لهم، ولا يُريدون أكثر من تطبيق ما أراده الله في هذه الأرض.
وهناك من الجماعات من تقول: ” أنّ لهم الدُنيا ومن أمسى عليها”، وأنّ “لهم الصدر دون العالمين”، وبما أنهم امتلكوا الدنيا وصدرها، فقد حكموا على شعوب جنوب شرق آسيا، بأن يكونوا خدماً لهم، ثم يتلون الآية الكريمة: “سبحان من سخر لنا هذا”.
وينسحب الأمر ذاته على الدول. فتلك الدول القوية تحالفت فيما بينها، وسخرت الضعيفة لخدمة مصالحها، بأن أعطت نفسها الحق في نهب خيراتها وثرواتها، وإعادة توزيعها.
فمن ترضى عنها الدول القوية من هذه الدول الضعيفة، تعطيها زاد يومها، ومن تغضب عليها، يموت شعبها جوعاً، محروماً حتى من خيرات أرض بلاده.
لكنّ الله كان لهم بالمرصاد، واكتشف لعبة القويّ على الضعيف، وخضوع الضعيف للقويّ، فحمّلهما الوزر نفسه، ووضعهما في كفة واحدة.
وقرّر مُعاقبتهما في الدنيا قبل الآخرة، وذلك بتحويلهم إلى حيوانات، بشرط أن يختار الشخص سواء أكان قوياً أو ضعيفاً الحيوان الذي يريد أن يتحوّل إليه، مُبينًاً سبب اختياره لهذا الحيوان، فإذا كان السبب مُقنعاً استجاب الله إلى طلبه.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل سيختار القويّ حيواناً قوياً، والضعيف حيواناً ضعيفاًً؟.
والسؤال المُلحّ، هل سيختار الضعيف أقوى الحيوانات، لينتقم لنفسه من القوي، أم أنه تعلم الخنوع والقبول بما تيسر؟.
والسؤال الأكثر إلحاحاً: هل سيختار الناس جميعاً، بعد أن تعلموا القتل واعتادوا عليه، نوعاً واحداً من الحيوانات، مع العلم أن الحيوانات إذا كان لها نفس النوع فلا يقتل بعضها بعضاً؟.
انتظر الناس في طوابير، لكي يتحوّلوا إلى حيوانات، ويروْا بأمّ أعينهم: من هو الأقرب إلى الله؟.
وإذ بالمُنادي يُنادي: هلمّوا أيّها الفلسطينيون، وقولوا لنا قبل كل شيء: لماذا انعدم الحبّ بينكم من دون خلق الله؟.
يجب أن تعلموا جميعاً، أنّ الله جعلكم أوّل المُتحولين لانعدام الحبّ بينكم، وليس لأنكم الأقرب إلى الله كما توهّمتم!
والآن، فليتقدّم أحدكم ليختار حيوانه المفضل، فتقدّم نحوه نصف الطابور، والتفوا حوله على شكل دائرة، وبدؤوا يتكلمون معاً، وفي نفس الوقت.
سمع المُنادي أحدهم يقول: بسم الشّعب، فغضب من يقف على يمينه، وقال: الشّعب وحده لا يحل المشكلة، يجب أن تقول: بسم الأمة، فردّ من يقف على يساره، وقال: الأمة عجزت عن الحل، يجب عليك أن تقول: بسم الله، فصرخ من يقف أمامه وقال: لا صوت يعلو على صوت المعركة، فضحك كل من سمع كلامه.
وصاح آخر: باسم الكادحين العرب، فاحتج مَنْ بجانبه، وقال: لماذا العرب؟ هذا خطأ تاريخي يا رفيق!، سوف يتهمنا الكادحون من غير العرب بالعنصرية، وبذلك نخسر الرأي العام العالمي.
صاح بهم المنادي: ارجعوا إلى أماكنكم، يكفي أن يتكلم واحد منكم، وباسم الجميع حتى يسمعكم الله، وعلى مضض، سمحوا لأحدهم بالكلام دون أن يُلزمهم كلامه بشيء، فقال المنادي: إذا لم تختاروا أحدكم، وتلتزموا جميعا بما يقول، ستفقدون حقكم في الكلام.
غضب أحدُ الواقفين في الطابور، فخلع حَطته وعِقاله، ورماهُما أرضاً، وتوسّط الناس، وقال بصوت مبحوح من شدة الغضب: “وَلكمْ بَطلتوا تِستحوا، ولكمْ خافوا الله يا جماعة، ألا يكفيكم خلافاً أمام الناس؟ أتريدون أن تختلفوا حتى أمام الله؟ فمن الذي سيسمعنا بعد الآن؟”
بعد أن سمع الناس هذا الكلام الجارح، من هذا الرّجل الغاضب، قالوا بصوت واحد: “خير من يُمثلنا هذا الرّجل الغاضب، الذي لا يخشى في قول الحق لومة لائم، فهو يغار علينا أمام الله، وليس أمام الناس فقط، تقدّم يا هذا، وأسمِعْهم رأينا”.
تقدم الرّجل الغاضب وقال: “أرجو المعذرة سلفاً، عمّا سأقوله عنكم إليكم، فأنا لا أتمتع بدبلوماسية السياسيين، ولم أتعلم النفاق والدجل في دكاكين السياسية العربية، ولا أخاف من نشر الغسيل، بأنواعه، النظيف والمُتسخ والمرئي والمستور.
نحن نقمع الرأي الآخر، ولا نعترف به، ونمتلك الحقيقة دائماً، وننكرها إذا جاءت على لسان الآخر.
لقد أغرقنا مُجتمعنا في دوّامة العُنف المُتبادل، حتى فقد ثقته بأطراف النزاع جميعاً، وهيأناه لقبول قوى جديدة قديمة، تحلم منذ مدة طويلة أن تنقضّ عليه، لتخلق أوضاعاً جديدة، لم تكن في حُسبان أحد، عندما حوّل البعض ألوان العلم الفلسطيني إلى لون واحد.
احتجّ أحد الأشخاص، وصاح بأعلى صوته قائلا: “من أنت أيها الرّجل الغاضب؟ عرّفنا على اسمك الحقيقي أو الثوري أو الحركي أو حتى كُنيتك؟ وقل لنا من أيّ البلدان قدمت؟ ومن الذي أرسلك إلينا؟ وكيف استطعت الوصول إلى قلوب الناس بهذه السرعة؟
نحن لا نعرفك من قبل، حتى أنك لم تبدأ حديثك بآية من القرآن الكريم، ولا حتى بحديث شريف، كغيرك من الخطباء، كم تبْدُ غريباً يا هذا”!.
رد عليه الرجل الغاضب قائلا ً: “أنا لا أريدك أن تعرف اسمي الحقيقي، كما أنه، ليس لي اسم حركي أو ثوري، فقد مللت الأسماء كلها، لا بل نسيتها، وليس لي كُنية، فلم يعد للأسماء التي تبدأ ” بأبي فلان ” أيّ معنى، بعد أن اكتشفنا، أنهم يتغطون تحت أسمائهم الكبيرة، وهم صِغار.
أما هذه الأسماء التي ذكرتها، فقد كنت أنا، وأمثالي، خارج اهتماماتهم، هم يريدون، من يعوم في بحرهم، ويسبّح بحمدهم، ويمشي في فلكهم، ويتغزل ببطولاتهم، وأنا لا أتقن هذا الفن.
أنا لا أحفظ من القرآن، إلا ما يلزمُني في صلاتي، ولست ممّن يسترزقون به، ولا من الذين يستخدمونه لفكّ الحصار، ولا من الذين رفعوه على أسنة الرماح.
نحن الآن أحوج ما نكون إلى اكتشاف عيوبنا، والاعتراف بها، دون أي تجميل زائف، أو تزوير مُتعمّد”.
بعد أن سمع الناس كلام الرجل المُحتج، واعتراضه على الرّجل الغاضب، قاموا بإسكات المُحتج فورًا، وطالبوا الرجل الغاضب، بالاستمرار بالحديث نيابة عنهم.
تحمّس الرجل الغاضب وتابع قائلاً:
“نحن شعب لا يَبني الواحد منا نفسه، بل ينشغل في هدم ما بناه غيره.
ليس مُهمًا، أن ننجح، لكن المُهم، أن نُفشل الناجحين.
ليس مُهماً أن نشرب، لكن الأهم، أن يشرب غيرنا كدراً وطيناً.
نقول بألسنتنا، ما ليس موجودًا في أفئدتنا، يتغيّر ولا يُغيّر من يُصبح مسئولا، وتتغيّر نظرتنا له، وسيختلف كلامُنا أمامه، عن كلامنا مع بعضنا البعض.
نعمل في السر، ما نستحي منه في العلانية، لهذا نمتلك الكثير من الأقنعة، ولكلّ مُناسبة قناعها.
ليس الفرح هدفنا، لكننا نحاول قتله في قلوب الفرحين، وإذا لم نستطع نتظاهر بأنّا فرحين.
ننحر الذبائح، ونطبخ المناسف، لا من أجل إكرام الضيف كما ندّعي، ولكن من أجل أن يمدحنا ذلك الضيف، ويتغنى بكرمنا الآخرين.
حتى العلم، لم يُغير من سلوكنا وفكرنا، ولم نعد ندرسه لذاته، وإنما ليُقال عنا مُتعلمون، فبعد الحصول على الشهادة، نقوم بتعليقها على الحائط كلوحة فنية، ونركب عليها لنصل إلى أهدافنا.
نحن “نفرمل” الماشي، لكيْ لا يصل، تحت ذريعة مساعدته للوصول إلى هدفه، ونمنع عمّال المصانع، من الوصول إلى مصانعهم، تحت ذريعة الأمن والأمان.
نحن نحوّل الهزيمة إلى “نصر وهمي” وقت ما نشاء، لهذا أنشأت كل فئة “إعلاماً راقصاً” يبث وجهة نظر صاحبها، مهما كانت درجة صحتها، ونقنع أنفسنا بعد ذلك، بالانتصار، ونتوّهم بأننا أقنعنا الآخرين.
نحن نكيل بمكيالين، في حياتنا اليومية، فإذا عمل اثنان العمل نفسه، ندين أحدهما ونجعل من الثاني بطلا ً.
إننا نطالب غيرنا، بعمل الصواب، ونعفو أنفسنا، ونبرّر أعمالنا، ولا نضع أنفسنا مكان الآخرين، لنعرف ظروفهم، بل نصدر الأحكام عليهم، بحسب قربهم وبعدهم عنا.
ما زلنا ندافع عن الخرافة والسحر والشعوذة، وما زلنا نقرأ القرآن على الماء، ونستخدمه في علاج أمراضنا المستعصية
وننتظر الحجر والشجر، لمساعدتنا في القضاء على عدوّنا.
ونستعين بالجن، في عملياتنا الجراحية، وعلّمنا وتعلّمنا مراقبتهم وتصنيفهم، وانشغلنا بإخراجهم من أجسادنا.
إننا لا زلنا نزرع العداوات بيننا، وندّعي عدم التدخل في شؤون غيرنا، ونظهر معهم في المناسبات، وكأنّ الوئام والانسجام والهدوء والاستقرار هو السائد بيننا.
نحن نبدّد طاقاتنا في غير قضية، وأشغلنا الناس وأنفسنا بأمور جانبية، ولم نكتف بذلك، بل تشدّدنا فيها، كفرض النقاب، وتقصير الثياب، وحرمة الغناء والتصوير، والاختلاط، وتساهلنا في مواقع الإنتاج والعمل وحقوق الناس.
نحن مُغرمون بالتقليد الحاسد، فإذا بنينا بيتاً، يجب أن يكون أجمل من بيت فلان، حتى إذا زوّجنا بنتاً نطلب مهراً كمهر ابنة عمها أو ابنة خالها.
حتى الحب أفسدناه، فلم نسمع من أغاني”فيروز”الكثيرة، إلا أغنيتين.
الأولى، وتتعهد فيها بالسهر، طوال الليل، لمراقبة القمر، خوفاً عليه من السقوط، في حضن جارتها، التي هي زعلانة منها، لأنه لو نامت فيروز، وسقط القمر، فستسرقه جارتها، وتهديه إلى حبيب فيروز، فينساها حبيبها، ويحبّ جارتها.
الثانية، وتطلب فيها من حبيبها أن يكذب عليها، ولكن كذبة مش خطِيّة، إننا نعرف، كيف نقول الكثير الكاذب، كما لو كان صدقاً، كما نعرف عندما نرغب، أن نخلق من الخرافة صدقاً.
تعلمنا من الديوك صراعها، ومن الأفاعي لدغتها، ومن الثعالب خداعها، ومن الصقور عُدوانيتها، ومارسنا غزو القبائل، وأسرنا الحرائر، وقتلنا الضمائر، وحرقنا المكاتب والمزارع، ورقصنا بالأموات في الشوارع.
تدخل المنادي، وأوقف الكلام قائلاً: “لكن قل لي بالله عليك كيف نما هذا الحقد بينكم، حتى وصل الى هذا الحد؟”
فقال الرجل الغاضب: “هم يا مولاي، لا يريدون نبش الماضي، ويُفضلون الحاضر، ونسوْا أو تناسوا، أن تجاهل المشكلة، لا يعني حلها، اسمحوا لي، أن أعود إلى الماضي، الذي هو ليس ببعيد.
فقد سادت ثقافة العائلة بيننا، ورفعنا شعار “أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب”.
هل تعلمون من هو هذا الغريب؟ هو العائلة المنافسة في كل قرية ومدينة، والشغل الشاغل لأيّ عائلة، هو إضعاف العائلة المنافسة لها، حتى وصل الأمر، إلى قتل المتفوقين واللامعين فيها، لكي لا تقوم لهذه العائلة قائمة.
خلقتمونا يا مولاي، قبائل لنتعارف، وتعارفنا بالإثم والعدوان!!
وفي شرع العائلة، لا يتزوج الرجل إلا من ابنة عمه، وعليه سيُفرض على أحد الطرفين القهر الأبدي، حيث لا يستطيع أي من العروسين الفكاك من الآخر، تحت ذريعة العرض واللحم والدم، ويبقون على خلاف إلى أن يشاء الله.
وهذا الخلاف سينعكس على الأسرتين معاً، ويمتصه الأولاد منذ نعومة أظفارهم، ويتمترس كل ولد خلف أمه أو أبيه، وبهذا ينتقل الخلاف للأولاد والأحفاد من بعدهم.
قد لا يكون هذا الخلاف ظاهرًا على السطح، أو حتى للآخرين، فنحن نتقن طمس الحقائق وإخفائها.
أمّا اذا قرّرت عائلة مُصاهرة أخرى ، فيتمُ على الفور تبادل كلمات الترحيب، ويقوم مُمثل كل عائلة بمدح العائلة الأخرى، ويصفها بالكرم والشهامة والمروءة وحسن الاستقبال.
بعد الانتهاء من المراسم، تعيد كل عائلة حساباتها، وتبدأ في تغيير مواقفها.
فأهل العريس، يودون تخفيض مُتطلبات العرس إلى حدها الأدنى، بالرغم من قولهم في البداية” نحن جمال، وَما عليكم الا تحميلنا”.
أما أهل العروس، فيرفعوا سقف مطالبهم إلى حدها الأعلى، تطبيقا للقاعدة التي تقول “ما لم يخرج مع العروس، فلن يلحق بها”.
يأتي حفل الزواج، ليكون استعراضاً للقوة والغنى من قبل العائلتين معا، مُتجسدا ً بغنائهم : “ياعريس، لا تهتم إحنا شرّابين الدم”.
بعد ذلك تبدأ كل عائلة بتجفيف صفات العائلة الأخرى، والتي قيلت في الاحتفال، وتصبح العائلتان عدوتين بعد أن كانت صديقتين، حتى ولو لم يظهر ذلك للعلن.
في الماضي القريب، اذا تزوّج الرجل من خارج قريته، فهنا تصبح معركة حقيقية بين بلدين، تُفرض فيه ” شاة الشباب”، وهو مبلغ من المال، يدفعه العريس، إلى أهل قرية العروس، مُقابل تنازلهم عن العروس، ولك أن تتخيّل – إذا دفع العريس هذا المبلغ أو لم يدفع – نوع العلاقة التي ستسود بين العروسين وبين القريتين عندئذ.
وأنتم يا مولاي جعلتم الزواج سكنًا، يفيض حُبًا، ويشعُ سعادة، فحوًلناه إلى وكر، ينفث منه وإليه السم الزعاف، ويخرج منه أفاع وعقارب، تتنكر لمن أسقاها اللبن وهي صغيرة.
ثم انتقلنا إلى ثقافة “الأسرة النووية “، بعد أن انسلخنا عن العائلة، فقد أصبحت أسرة العريس تأسر العروس لو استطاعت بعد الزواج.
وبالعكس يُصبح الشغل الشاغل لأهل العروس، سلخ العريس عن أهله والانفراد به إذا استطاعوا.
وهذا يعود إلى البدايات الأولى، فمن تلِد البنت من النساء، يتوّلد عندها حسدٌ في داخلها، لمن تلِد الولد، وتنتظر هذه السنين كلها، لتقول لمُنافستها: “ليس مهماً أن تفرحي في البداية، لكن الأهم، أن تحافظي على هذه الفرحة، فقد جاء اليوم الذي آخذ فيه الولد والبنت معاً”.
وتردّ عليها مُنافستها عملياً، عند إخراج العروس من بيت أهلها بأغانٍ استفزازية، منها “كانت ليهم وصارت لينا الغزالة، كانت ليهم وصارت لينا النشمية …”، وبعد أيام قليلة، تصبح الغزالة شيطانة، والنشمية قطّاعة.
وتتحالف العروس مع أمّها عملياً؛ لتثبت بأنها لا زالت لأهلها، وليس كما ادعت أم العريس.
وهكذا تتحول الحياة بين الأسرتين إلى مباريات لا بد فيها من خاسر، ومن يخسر في الأولى، يعقد العزم أن يربح في الثانية.
والمصيبة الكبرى، إذا بقي أحد الفريقين خاسراً، فيستخدم يده في المباراة، ممّا يضطر الحكم إلى إخراجه من الملعب، وتنتهي المباراة، بعد ضياع هذه السنين هدراً، مُخلفة وراءها أولاداً، يمتازون بالتعصب، وعدم الانتماء، والخروج عن القيم، والهروب من الواقع، لتعود الكرة من جديد إلى الأجيال التالية.
كنتم يا مولاي، قد جعلتم من الزواج مودة ورحمة بين الأهل، يجمعهم على أواصر الخير والمحبة، فجعلناه نحن عداوة معلنة وخفية.
وبهذه المناسبة، لن نتغيّر ما لم نغيّر من نظرتنا للمرأة، ودورها في المجتمع، وطريقة التعامل معها.
فيجب إنشاؤها على نوع من الاستقلالية، والمساواة، والشعور بالنديّة، وتنمية الوعي عندها، فالمرأة تعُطي، لكي تأخذ، فإذا لم تأخذ، سوف لن تعطي، وإذا لم تعطِ، سيتولد العنف في المجتمع، كما هو حاصل الآن.
أما نحن، فعندما تولد البنت تسْودّ وجوهنا، ونتبجّح بغير ذلك، وعندما تكبر قليلا، نُشعرها بأنها عبء إضافي علينا، ونُفهمها بأنها ضِلع قاصر، تحتاج إلى من يحميها، ونمنعها من السفر وحدها، ونرسم لها حركاتها، وما زلنا نعتبر حجابها وخروجها إلى العمل مشكلة، وزواجها أم المشاكل.
هذه النظرة الدونية للبنت منذ ولادتها، لا بد أن تثمر مخاطر كثيرة، إنها لا تزرع الفضيلة في نفسها، بقدر ما تزرع الرعب والخوف، وتحصد إنسانة مُهتزة، لا تصدر حكماً ولا تبد رأياً ولا تتخذ قراراً.
إننا نخلق صغاراً مُستبدين، يُحاولون أن يُملوا آراءهم، لمُجرّد أنهم ذكور!
وبعد أن فشلت الأسرة بعد العائلة، وتقطعت أوصال مجتمعنا، سادت ثقافة “الأنا”، واستولت على عقولنا.
بالأمس سمعت من يقول: لم يُعجبني ما فعله إخوة يوسف بأخيهم، كان من المفروض أنهم قتلوه ثم ألقوه في اليمّ، لأنهم بفعلتهمْ هذه قد جعلوا أخوهم قائماً على خزائن مصر.
فردّ عليه آخر وقال: أنا لم يعجبني موقف يوسف من إخوته، فقد سامحهم وأكرمهم، وهذا لا يجوز، فالتسامح معناه التخاذل، وكان يجب عليه أن يكيل لهم الصاع صاعين.
وقال آخر: أنا لست مُعجباً لا بموقف يوسف من إخوته، ولا بموقف إخوته منه، لكنني مُعجب جداً “بقابيل” الذي أنهى حياة أخيه ” هابيل” وإلى الأبد، فقد أراح واستراح.
لهذا يا مولاي أصبحنا نتقن ونتفنن في صناعة الخلاف والاختلاف، ونعدك أن نهديها للعالم بأسره، لتكون صدقة جارية، لنا أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة!.
لهذا يا مولاي أصبحنا في نظر العالم إرهابيين، يجب التخلص منا، وقبل أن يتخلصوا منا، نأمل تحويلنا إلى “شنانير”.
فالشنار طائر جميل يحبه الناس جميعاً، وهو يُفضل الجري على المشي، فلا يستطيع أحد أن يمسك به، ويسجنه مثلنا، فنحن مللنا السجون جميعها.
والشنار لا يُفاجأ أبداً، فله قدرة كبيرة على التخفي والتمويه بين الصخور والأحراش، يُساعده في ذلك لونه الرمادي والبني، الذي لا يختلف عن لون البيئة المحيطة به، وعند الشعور بالخطر، يُصدر أصواتاًً تحذيرية مُميّزة تُبعدغيره عن الخطر.
أما نحن، فحياتنا كانت كلها مفاجآت مُبرّرة، ولم نتلوّن بلون البيئة، بل قمنا بصبغ أجسامنا “باللون الفسفوري” ليميزنا العدو، أما عند الشعور بالخطر فنختلف، ونلوم بعضنا بعضاً، ولا نلوم أنفسنا.
بيننا وبين الشنار يا مولاي شبه كبير، فكلانا مطلوب للصيادين، وهم يتفنّنون في صيدنا، وقد جربوا كل أنواع الصيد فينا، وإليك نعدد هذه الأنواع:
النوع الأول من صيد الشنانير: يتم بإطلاق النار عليها مُباشرة، وقد جرّبوه مِراراً فينا، ويمتاز هذا النوع، بأنّ الصيّاد يُحدّد العدد الذي يريد صيده وزمانه ومكانه.
وأما النوع الثاني: فيكون في شهر آذار من كل عام، عندما تضع الأنثى بيضها في عش أرضي تختار مكانه بعناية، وبرغم ذلك، يكتشفه الصياد، فيقوم باستبدال بيضه بحجارة مُشابهة، ويستهلك بيضه في حياته اليومية، أو يضعه تحت دجاجة راقدة، فيفقس البيض شنانير، يُربيها عنده في قفص،وقد جربوه معنا، كثير منا وجد نفسه يعيش في قصور وفلل، لكنه في الحقيقة يعيش في قفص.
وتنطلي هذه اللعبة على الشنار، لأن الأنثى تضع بيضها، وتخرج من العشّ فوراً، من دون التعرّف إليه، ليأتي الذكر، ويرقد على البيض، وفي هذه الأثناء، تقوم الأنثى بحراسة العش.
تماماً، مثل الكثير من نسائنا في هذه الأيام، فالمرأة بعد أن تضع مولودها، تسلمه للخادمة، لكي تعتني به، وتذهب إلى عملها، وفي نهاية الشهر تدفع راتبها للخادمة، وبهذا تصبح الأم هي التي تعمل عند الخادمة.
وتنطلي هذه اللعبة على الرجل أيضاً، كما انطلت على الشنار.
وأما النوع الثالث: فيُسمى “بالصيد الجائر ” فقد لا يكتفي الصيّاد بالبيض وحده، بل يُريد الذكر والأنثى أيضاً، فيقوم بنصبِ شَرَك بباب العش، وقبل أن يدخل الذكر إلى عشه، يجد نفسه فيه، فيأتي الصياد ويأخذه حياً، ويعيد نصب الشرك ثانية، وينتظر مجيء الأنثى، التي طال انتظارها للذكر، فتذهب إلى العش للاطمئنان عليه، فتقع هي الأخرى في الشرك، فيأخذها الصيّاد مع الذكر، ويصنع منهما عشاءاً فاخرًا في ذاك اليوم.
يتم هذا النوع بصمت، وبدون سلاح، يُصاد في عقر داره، مما يُكسبه عاراً أبدياً، ويُكسب الصياد النشوة والرغبة في التكرار.
لكن الشنانير سرعان ما تكتشف اللعبة، فتحبط عمل الصياد.
أتمنى أن نتعلم من الشنار، لأنّ كليْنا يتعرّض بين الفينة والأخرى، للصيد الجائر، لكنه يكون حذراً قبل أن يختار مكاناً، ليضع فيه عشه، أما نحن، فكنا نُصور أعشاشنا، ونعرضها على الفضائيات.
وأما النوع الرابع: فيستعمل عندما لا يطمع الصياد بطائر أو اثنين، بل برفٍّ كامل، فيخلط القمح مع المُخدر، ويضعه في مكان مكشوف، ليأكله أكبر عدد من الشنانير.
يأتي رف الشنانير، ويبدأ بأكل القمح المُخدّر، ومن يأكل أكثر، يدوخ أولاً، إلى أن يحضر الصياد ويمسك بمن تخدّردون عناء.
تكتشف الشنانير اللعبة، وتُعرِض عن القمح المُخدّر، وتغادر المكان بسرعة هائلة، لكن الشنار يتعلم من مرة واحدة، أما نحن، فكم من مرّة مُسكنا مسْك اليد؟ وكم من مرّة أكلنا من القمح المسموم؟؟
أما النوع الخامس: ويستخدم عندما لا يستطيع صياد واحد أن يقوم بالمهمة منفرداً، فيجتمع فريق من الصيادين، ويقومون بتوزيع أنفسهم إلى مجموعات، وكل مجموعة تذهب إلى جبل من الجبال المتقابلة والمتجاورة، وتنتظر قدوم الشنانير.
وبعد أن يتفقوا على توزيع الغنائم، تبدأ العملية بقدوم رف الشنانير إلى أحد الجبال، فتقوم مجموعة كل جبل بإزعاجها، فتطير إلى جبل مجاور أو مقابل، وهكذا يتعب هذا الرفّ ويمسكونه، ولا تنفعه سرعته في الجري، ولا قدرته على الطيران .
وهنا أريد أن أسال الشنار، إذا كان قدرك أن تُصاد، وخيّرت في ذلك، فأيّ الأنواع تختار؟ فأجابني: أنا ما هنت أمام الصيادين جميعهم، على اختلاف طرق صيدهم، ولكن هنت عندما أصبح الشنار صياداً للشنانير!.
والشنار يأكل اليرقات والخنافس والجنادب والعناكب عند الضرورة، كما أكلنا “الجراد” في مطلع القرن الماضي، ولكنه يختلف عنا، بأنه لا يأكل لحم أخيه حيّاً أو ميّتاً.
ولكننا تعلمنا من الشنار، المحافظة على النوع، وعلى حب البقاء، إذ تجري الفراخ بعد خروجها من البيض مباشرة وراء أمها، لتعلمها الاعتماد على النفس ومن أوّل يوم، فإذا فوجئ الذكر والأنثى والفراخ بصيّاد، يطير الذكر، وتطير الأنثى، ويتركون فراخهم يتخفون، كل بطريقته الخاصة، وإذا أحد منهم لم يستطع ذلك، ينام على ظهره، ويقلب فوقه حجراً صغيراً ليتخفى تحته، وبعد زوال الخطر يلتقون جميعاًً.
وما هي إلا بضعة أيام، حتى يُكوّن الذكر والأنثى والفراخ رفاً من الشنانير، يختار منطقة، يعتبرها موطناً مؤقتاً له، لتعود الفراخ إلى موطنها الأصلي.
كما أن الشنانير لا تحب الجو الحار، ولذلك تقضي معظم النهار داخل الأحراش وعلى رؤوس الجبال، أما نحن فقد استمرأنا الجلوس “وراء المكاتب” وأعجبنا عقد المؤتمرات في الفنادق.
كما أن الشنار لا يوجد مُنفرداً، ولكن يوجد في أسراب، قد تصل إلى أكثر من مائة طائر، يقودها طائر واحد، أما نحن فكلنا قادة”.
بعد أن سمع المُنادي من الرجل الغاضب كلّ هذا القول ، غاب بُرهة من الزمن، وعاد ليقول: “أبشروا أيها الفلسطينيون، إن الله قد استجاب لطلبكم، بتحويلكم إلى شنانير، لكنه أخذ عليكم ميثاقاً غليظاً، بعدم الرحيل عن وطنكم، ومن يرحل عن وطنه بعد ذلك، سيُرجعه كما كان، فهل أنتم موافقون؟”
فرد الرجل الغاضب على الفور قائلا ً : ” وعهد الله ما نرحل، نجوع نموت ولا نرحل”.
فرح الفلسطينيون بهذا الخبر، واعتبروه أول وآخر إنجاز عظيم من قيادتهم الحالية، التي استطاعت تحريرفلسطين لتصبح أرضاً للشنانير.
علمت حيوانات العالم بما حصل في أرض الشنانير.
الصقر طائر عُدواني، لا يستطيع مقاومة الجوع، وموجود في كل مكان.
والثعلب حيوان مُفترس شرِه، يُحبّ الأكل، بدون أن يبذل جهداً، وله مناطق نفوذ من ضمنها أرض الشنانير.
أما الطاووس فمُعجب بنفسه.
والدبّ صيّاد ذكيّ.
والنسر يعيش في قمم الجبال العالية البعيدة، يصطاد الحيوانات الكبيرة، بضربها بجناحيه، فتهوي أرضاً، وبعدها يقوم بافتراسها.
والجمل حيوان ضخم، تراه من بعيد، فيُعجبك منظره، وعندما تعلم أن هِرّاً يقوده، يسقط من عينك.
اسيقظ صقر من نومه في أحد الأيام حالماً، بتجميع بني جنسه المنتشرين في أنحاء الأرض. وعندما سمع بأرض الشنانير سال لعابه ، وتغيّر حلمه، ليُصبح “ليس تجميع الصقور في أي مكان، بل تجميعها في أرض الشنانير”، ولسان حاله يقول : سهل أن تحلم، لكن الأصعب هو تحقيق ذلك الحلم.
لتحقيق هذا الحلم لا بد من دعم إلهي، يجب إقناع الصقور أولاً، بأن الله اختارهم من دون غيرهم، ووعدهم بأرض الشنانير، ولن يرضى الله عنهم، إلا إذا حققوا رغبته في ذلك.
كما يجب إقناعهم بأن الجنة في الواقع جنتان: الأولى أرض الشنانير، ولن يدخلوا الجنة الثانية، إلا إذا دخلوا الأولى أولاً.
لا يكفي الوعد الإلهي وحده، بل لا بد أن يساعده بُعداً معنوياً آخر، فالصقور مُتواجدة في كل المناطق، وفي كل منطقة هناك مُتنفذون غيرهم، ولا تملك الصقور حريتها بالكامل، حيث يذكر التاريخ، أنهم قاموا مرّة بإزعاج الطاووس، فأزعجهم، فلا بد من استغلال هذه الحادثة المهمة في حياة الصقور، والتركيز عليها، وتخويف بقية الصقور في كل مكان بتكرارها.
لا يكفي البعد الإلهي والمعنوي، بل لابد من بعد حيواني للموضوع. يجب أن تقتنع جميع حيوانات العالم بأنّ أرض الشنانير، هي للصقور فقط.
لايكفي ذلك، بل يجب تجنيد كل حيوانات العالم لتحقيق هذا الهدف، لا بل الدفاع عنه، وبكل إمكاناتها، وسوف نتهم كل من لا يعجبه هذا الحلم، بأنه “ليس حيوانياً”، بل هو “إنساني”، وهذا لا يجوز في شريعة بني حيوان، التي نسير عليها.
“لتحقيق أي حلم كبير، لا بد من وجود مدخل له ، ثم تجزئته الى أحلام صغيرة، نسعى لتحقيقها، وتحديد زمن كل منها.
لا نستعجل الأمور، ولا نحيد عنها، ولا نخلطها، فيذهب لونها”، قال الصقر ذلك، وبحزم أمام زملائه الصقور.
وقال صقر آخر، لا نريد أقوالاً، بل نريد أفعالاً، أرض الشنانير ملأى بالثعالب، والثعلب معروف عنه، أنه يُحب الصّيد ولا يُحبّ أن يصيد، فإذا أوهمناه بصيد دسم يوميّ، يصله إلى باب جُحره، سيقف إلى جانبنا، لا بل سيدافع عنا، ليس لسواد عيوننا، ولكن لتحقيق مصالحه الشخصية.
والثعلب وحده لا يكفي، فهو أصبح الآن هرماً، وما تبقى من عمره قليل، لا بد من إقامة علاقات وثيقة مع النسر، فله مستقبل واعد، وقد يكون سيد الموقف يوماً ما.
وإذا حصل ذلك، سنجعل النسر يضرب الطاووس بجناحيه، فيلقيه أرضاً، وبهذا نكون قد انتقمنا من الطاووس، وجعلناه عِبرة للجمل، الذي كان يُحدّث نفسه بالتدخل في أرض الشنانير.
أما الدّب فموضوعه سهل، فهو غريب عن هذه المنطقة، نجمه بدأ يصعد، ولا يريد أن يقف في طريقه أحد، فنعده بازاحة أكبر عقبة من أمامه، وهي الصقور، فيسكت على الأقل، ولا نريد منه أكثر.
حدث كل هذا والشنانير مشغولة في مشاكلها الداخلية، صحيح أن الله حوّلهم الى شنانير، لكنهم فهموا الرسالة خطأ، هو حوّل أشكالهم وليس عقولهم.
سمعت الشنانير بالخبر، فانقسمت كعادتها، قال الشنار الصخري: إن الثعلب صديقنا، وهو الأقرب لنا، يفهمنا ونفهمه، وذاق طعم مناسفنا، التي كنا نضع له رأس شنار، بدلاً من رأس خاروف فوقها، وقد أعجبته مناسفنا، وكان يُعرب عن ارتياحه لنا في كل مرةن نلتقي فيها على العشاء، ثِقوا بالثعلب فهو الذي يحميكم من الصقور.
أما الشنار السهلي فقال: هناك نار بعيدة أشعلها الدب، فقد تصل إلينا، وإذا وصلت ارتاحوا وناموا ليلكم الطويل، فالدب وُجد للدفاع عن كل الحيوانات المُفترَسة، ونحن من ضمنها، وعندما، يدافع عنا، يكون بذلك قد انسجم مع معتقداته، وليس مِنّة منه علينا، صحيح أن الدب غريب عنا، لكن إذا دافع عنا، نعده بصبغ ريشنا باللون الأحمر، إكراماً له.
أما الشنار الرملي فقال: “أرى أن ندعو النسر للغداء، ونقيم له حفلة تليق به، ونعِده بأن نعطيه كل قمم جبالنا العالية، ونبقى نحن بلا جبال، ونكتفي بالصحراء، فهي التي تليق بمضاربنا، ونطلب منه الدفاع عنا”.
أما الشنار الغوريّ فقال: “أنتم نسيتم الطاووس فهو على خِلاف مع الصقور، وطِبقاً للقاعدة التي تقول: “عدوّ عدوّي صديقي”، فاذا أقمتم علاقة معه، سهّلتم على أنفسكم، فهو لا يحتاج إلى إقناع.
تدخل أحد الشنانير قائلاً: “لكن الطاووس مُتورط مع الثعلب، والذئب، والنسر”، فأجابه الشنار الغوري بدون تفكير: “سندعو للطاووس بالنصر بعد كل صلاة، فالدعاء واجب شرعيّ علينا، نسقطه من فروضنا، ويستفيد منه الطاووس، وبهذا نكون قد أضفنا الى ميزان حسناتنا دون أن نتعب أو نعمل، فقد جعلنا الدعاء لمن يريد حسنات بلا عمل”.
أما الشنار البلدي فقال: “إياكم والاعتماد على الغير، ما حكّ جلدك مثل ُظفرك، اذهبوا للجمل، واعرضوا عليه مشكلتكم، فالجمل كبير في حجمه كفيل بحلها”.
فأجابه أحد الشنانير: “لقد ذهبنا للجمل، وعرضنا عليه المشكلة، وكنا نعلم أن طعامه المفضل هو” الصبِر” وكل نبات فيه شوْك، لكننا وجدناه يأكل بطاً مشوياً، ويتحلى بوزة بعد العشاء، ويرقص مع سحْلِية”.
وعندما دخلنا عليه، بالكاد تعرّف علينا، وقبل أن نتكلم ويعرِف ما نريد، قال لنا اذهبوا أنتم الآن، وسأحضر شخصياً عندكم، لأرى أوضاعكم عن كثب، وذهبنا، وللآن لم ولن يصل .
فردّ عليه الشنار البلدي فوراً: “أنا لن أنتظر قدوم الجمل، ليشحذ كل شنار منقاره، ويدافع عن نفسه، وقبل أن يُنهي كلامه، وإذ بجموعة من الصقور تهاجمهم، لكن كيف عرفت الصقور بالاجتماع؟.
هرب من هرب، وبقيت الشنانير البلدية تقاتل الصقور، إلى أن قتل أحدها، فقامت الصقور بنتف ريشه عن جسمه أمام الشنانير، فبانت عورته، جُنّتْ الشنانير وقالوا بصوت واحد: “كل شيء نقبل به إلا ” العرض”، مُستعدون للذهاب الى أقاصي الأرض، للحفاظ على عوراتنا مستورة”.
بدأت أرفف الشنانير تُحضر نفسها لمغادرة الأرض، حفاظاً على العرض.
حضرت بقية الشنانير، تستطلع الخبر، وعندما حضر الشنار الغاضب ورأى أرففاً تستعد للرحيل، جُنّ جُنونه وقال لهم: “إلى أين أنتم ذاهبون؟، ألم تسمعوا بأنه ليس على المريض حرج؟، إذا كان المريض ليس عليه حرج، فما بالكم بالميت؟.
وما تسمونه “عورة” هو عضو من أعضاء الجسم، مثله مثل العين واليد والرجل، وجميع أعضاء الجسم مُهمة، فلا فضل لعضو على آخر، إلا بإتقان الدور الذي وُجد من أجله.
أنسيتم وعدكم لله، بأن لا ترحلوا عن وطنكم؟، أنسيتم أن الأرض هي العرض؟، إذا خرجتم من وطنكم أيها الشنانير، سيجمعون بيضكم، وسيضعونه تحت ” دجاجة “، ويستنسخون غيركم، والجيل المُستنسخ هذا، سوف لن يعرف نفسه، هل هو ابن الشنارة التي حملته في بطنها، وهو داخل البيضة، أو ابن الدجاجة التي تربّى تحتها؟”.
جميل عبود
آذار2009