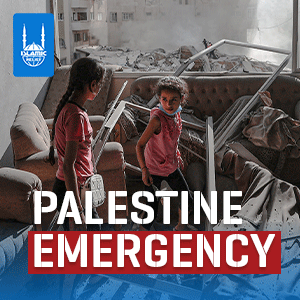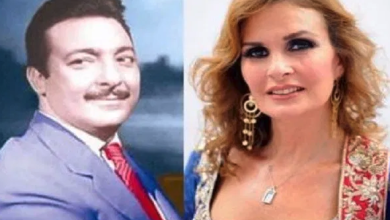إسحق سروي شامي، قاص يهودي -عربي فلسطيني
بروفيسور حسيب شحادة
جامعة هلسنكي
ولد هذا القاص، اليهودي-العربي، ابن البلد، في الخليل عام ١٨٨٨ وتوفي في القدس عام ١٩٤٩، وكان أبوه إلياهو قد غادر دمشق مسقط رأسه قادما إلى الخليل سنة ١٩٨٥ للتجارة بالحرير. وتحكي الأسطورة الخليلية عن إلياهو هذا (ت. ١٩٢٧) أنه كان ذا رباطة جأش معهودة وقد تزوج للمرة الثالثة من رفقة قسطل وهو ابن ستين عاما وأنجب منها أولاده الثلاثة، إسحق ويعقوب وداؤود. وإسحق الشامي، شرقي صهيوني مظلوم ومحتقر من قبل إخوته الإشكناز الذين نظروا إليه بروح التعالي، من أوائل كتّاب اللغة العبرية المعاصرة في البلاد. كان شامي ثنائي اللغة منذ نعومة أظفاره، تكلم العربية الفلسطينية مع والده، واللادينو، الإسبانية اليهودية، مع أمه الخليلية. وكان إسحق على اطلاع واسع بالثقافتين العربية والعبرية وكان قد تعلمهما في المدرسة اليهودية الدينية المحلية. من الواضح أن الشامي احترم ثقافة العرب وسُحر بها وكان يرتدي القمباز الخليلي إلا أنه في الوقت ذاته رأى محدوديتها ونقصانها ووصف خصلة الانتقام والعنف وحدّة الطبع عند العرب ووضع المرأة المزري.
غادر شامي الخليل وهو في الثامنة عشرة من عمره لامتعاظه من الدراسة في المدرسة الدينية هناك وانتقل مع صديق حياته داڤيد أڤيتسور إلى القدس للالتحاق بدار المعلمين “عزراه” الألمانية عام ١٩٠٦ لانهاء دراسته في المرحلة الثانوية. وبعد قدومه إلى القدس غير زيّه الشرقي واختار اللباس الغربي وتعرّض لموجة التأثير الصهيوني من قبل إسحاق بن تسڤي (١٨٨٤-١٩٦٣) والكاتب شموئيل يوسف عچنون (١٨٨٧-١٩٧٠) وكان داڤيد بن غوريون (١٨٨٦-١٩٧٣) قد علم باطلاعه الواسع على الثقافة العربية فطلب إليه عام ١٩٢٧ تجنيد عمال عرب للانضمام للهستدروت. وفي القدس تسنى لشامي التعرف عن كثب على كتّاب مثل يهودا بورلا المقدسي (١٨٨٦-١٩٧٠) الذي أتقن العبرية والعربية مثله أيضا. وهذان الكاتبان عرفا، على ما يبدو، اللادينو من البيت وربما الإيدش لغة القادمين الجدد في الهجرة الثانية، واللغة التركية لم تكن غريبة بالنسبة لهما إذ أنها كانت لغة البلاد الرسمية، وأما الألمانية فكانت لغة التدريس في “عزراه”. وفي العام ١٩٢٨ انتقل شامي مع زوجته الثانية ساره ابنة قليش إلى طبريا وبعد ذلك بثلاث سنوات انتقل مع أسرته إلى حيفا. وكانت مهنته تعليم اللغة العبرية في أماكن عدة في البلاد وخارجها، في دمشق وبلغاريا (قضى في بلغاريا ثماني سنوات وكانت ، كما صرح، الأحسن في حياته). كما وعمل سكرتيرا للطائفة اليهودية في الخليل ثم موظفا في محكمة. أراد دراسة المحاماة مع بن غوريون وبن تسفي في تركيا إلا أن أوضاعه المادية لم تسمح له يذلك. بالإضافة إلى خلفيته الثقافية العربية والعبرية القوية كان الشامي وقريناه بورلا وداڤيد أڤيشار على اطلاع واف بالثقافة الغربية الألمانية أيضا.
نتاج شامي ضئيل ربما بسبب صحته الواهية وتخبطات في هويته ومكانته في المجتمع، رواية بعنوان “نقمة الآباء (يقصد: إبراهيم وإسحاق ويعقوب) – قصة عن حياة العرب” ١٩٢٨ وصدرت في القدس عام ١٩٧٥ وست قصص قصيرة، ثلاث منها تدور أحداثها عن العرب في البلاد. ومما يجدر ذكرُه أن هذه الرواية هي الوحيدة في الأدب العبري الحديث التي يدور كل ما فيها من شخصيات ومناظر وخلفيات في فلسطين. البطل أبو الشوارب النابلسي يترأس وفد مدينته في احتفالات النبي موسى وتندلع المعركة مع أهالي الخليل فينهزم أبو الشوارب إلى القاهرة ريثما يتم الصلح. أخيرا قرر العودة إلى الخليل للحج والاستغفار من البطاركة الثلاثة وهناك يموت.
ومن المعروف أن أسلوب الشامي إِثنوغرافي (قد يكون شبيها بأسلوب جاك لندن) ذو لمسات عربية وشخصياته عرب ويهود شرقيون. والقصص الست هي:
“العاقر” ونشرت في هعومر عام ١٩٠٧
“فدية نفس” ونشرت في هعومر عام ١٩٠٧
“الهروب” ونشرت في هعڤري هِحداش عام ١٩١٢
“بين رمال القفر” ونشرت في موليدت عام ١٩١٣
“أب وبناته” ونشرت في هتقوفاه عام ١٩٢٣
“جمعة الأهبل” ونشرت في موزنايم عام ١٩٣٧. وقد صدرت هذه القصص الستّ في طبعات مختلفة، ١٩٥١، ١٩٧١، ١٩٨٣.
ويذكر أن قصصه هذه قد ترجمت إلى الإنجليزية تحت عنوان Hebron Stories عام ٢٠٠٠ وإلى الفرنسية Nouvelles d’Hébron عام ٢٠٠٦.
إضافة إلى ذلك نظم الشامي بعض الشعر بالعبرية وكتب بعض المقالات بالعربية حول الشعر العربي وروايات جورجي زيدان التاريخية وعن أصول المسرح العربي الحديث. كما وهناك مراسلات له لأصدقائه ومعارفه باللغتين العبرية والعربية يستشف منها الكثير عن شخصيته وأوضاعه. للأسف الشديد لا يوجد أي شيء مطبوع له بالعربية! ويمكن القول دون أي ريب أن مقولة يسرائيل زينجويل (١٨٦٤-١٩٢٦) التاريخية عن فلسطين آنذاك أنها “أرض بلا شعب وشعب بلا أرض” بناء على ما في نتاج الشامي من وصف، ما هي إلا من نسج الخيال الممجوج.
وتمتاز أعماله المعدودة هذه بالتركيز على عقدة واحدة وبطل واحد ومكان واحد وهذا ما نجده في الأدب الغربي. وقد لا نحيد عن جادة الصواب إذا ما قلنا إن إسحاق الشامي هو في الواقع الكاتب العبري الوحيد في الأدب العبري الذي خلق شخصيات ومناظر عربية فلسطينية من منظار داخلي ومباشر. وكان الأديب العبري المعروف أ. ب. يهوشوع (١٩٣٦–) قد صرّح عن هذه النقطة بما معناه “عرف الشامي سبيل الولوج إلى روح العرب بعين حادّة وتضامن عميق، وقد روى قصصهم بدون رومانسية مزيفة”. والحقيقة أن الشامي عبّرفي كتاباته عن موقف وسط، يصف العرب كأعداء يهددون تحقيق المشروع الصهيوني من ناحية ومن الناحية المقابلة يرى لزاما عليه إعلاء صوت الثقافة العربية الساحرة في رأيه، باللغة العبرية. أدبه فريد من نوعه. وكان صديقه الكاتب أشير براش قد قال عنه “إنه أحد براعم اليهودية الشرقية المتجددة في أرض إسرائيل”. وكان الباحث وأستاذ الأدب العبري في الجامعة العبرية، چرشون شاكيد (١٩٢٩-٢٠٠٦) قد وصف الشامي بـ”كاتب يهودي-عربي كتب بالعبرية”. على كل حال، يمكن القول إن الشامي الذي ولد وترعرع وعاش نصف قرن ونيّف في فلسطين، في ثلاث مدن مقدسة لليهود، الخليل والقدس وطبريا والذي لم يتلق تربية غربية كأبناء الهجرتين الثانية والثالثة إلى فلسطين قد ولج نفس الإنسان الفلسطيني العربي واليهودي العربي على حد سواء، وسبر أعماقها مع أنه لم يسمع بنظرية فرويد لا من بعيد ولا من قريب.
وقبل بضع سنوات، وبالتحديد عام ٢٠٠٤ اعترفت الجمعية الأكاديمية الفلسطينية بالشامي كأحد الأدباء الفلسطينيين الهامين. حبذا لو رافق مثل هذا الاعتراف شيء ملموس مثل نشر رسائله ومقالاته بالعربية والعمل على ترجمة قصصه إلى العربية. وفي تقديري يستحق هذا القاص الفلسطيني اليهودي -العربي إلى بحث معمق، أطروحة دكتوراة، أين طلابنا في الداخل أو في الخارج لاقتحام هذا الميدان؟